لاشك عند كل ذي بصيرة أن حمل الناس على القول الواحد، والرأي المتحد أشبه بالمستحيل، ذلك أن الله تعالى خلق الناس، وجعل لهم طرائق مختلفة في الفهم والتفكير، ويعسر عليهم أن يكونوا على رأي رجل واحد، ولما جاء الدين جاء بالفطرة فأتاح الخلاف وشرعه، وجعل من الدين أمهات ومحكمات يتحد حولها المسلمون؛ وهي محكمات في طاقة كل إنسان قال سبحانه[ما جعل عليكم في الدين من حرج] (سورة الحج)، ثم شرع الخلاف فيما دون ذلك، وكانت نصوص الدين المحكمة فيها من السعة لتراعي التفاوت والخلاف بين فهوم الناس وطاقاتهم، فنشأ الفقه والمدارس الفقهية على يد علماء الملة والدين، وكان الخلاف ظاهرا بين الفقهاء فيما يسوغ فيه الخلاف، ومضت سفينة الإسلام على ذلك، يرشدها القرآن، وتسندها السنة [ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين…] (سورة هود)
وأكد العلماء على هذا الخلاف المبرر الذي ينطلق أصحابه جميعا من نصوص الوحي، و ليس لأحد أن يلزم غيره بما يراه في المسائل الخلافية، فإن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، كما يقرر ذلك أهل العلم.
وقد رفدتنا كتب التاريخ والسير، بأن الخلاف في الفرعيات وجد من عهد الصحابة بلا نكير، واستمر به عمل المسلمين، وإن ضاق به صدر الغلاة في كل حقب الإسلام، ومَن منا لم يقرأ محاولة الخليفة المنصور أن يلزم الناس بكتاب الإمام مالك(الموطأ) وموقف الإمام مالك الحكيم، إذ أكد له أن الدين أوسع وأشمل من أن يختزل في الموطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن أكثر من مائة ألف من الصحابة كلهم صدروا عنه، ونقلوا الدين كل بحسب ما سمع من النبي ووعى؛ ولا يمكن حصر الدين في رواية أو روايات محددة هي ما شملها الموطأ.
وأقر الإسلام الخلافات الفقهية في الفروع، فكان علماء المالكية يجلون أبا حنيفة وصحبه، وعلماء الحنابلة يقدرون فقهاء الشافعية ويأخذون من اجتهاداتهم.
وبذلك ازدان العلم، وأخذت الكتب تُجّود حينا بعد حين، لأن العلم أصبح خلاصة الأفكار وزبدة الحوار.
وكان الفقهاء يدرسون أقوال غيرهم، ويحتفون بها فأعقل الناس من جمع إلى عقله عقول الناس، ذلك لأن العقول كالمصابيح إذا اجتمعت ازداد النور ووضح السبيل ولأن لكل عقل نوعاً من التفكير وبعداً خاصاً.
وقد أدركت البشرية أن اختلاف الآراء أمر طبيعي بين البشر ويحدث حتى داخل البيت الواحد وفي مسائل أقل بكثير من شأن الدين وأحوال الناس، ولا يمكن جمع الناس على كلمة واحدة أو رأي واحد فلكل منا وجهة نظر أو رأي خاص.
أدب الاختلاف
نعم قد يختلف الناس لكن المطلوب هو لزومُ مراعاة أدَب الخِلاف، وحسُن التعامُل معه، والتفريق بين أنواعه والحرصُ على إظهار رُوح التسامُح وعدم التنازُع المؤدِّي إلى الفُرقة والتطاحُن والتباغُض.
وواجب المحاور والمسلم بصفة عامة الإقرارِ بالاختلاف والتنوُّع كواقِع، مع وجوب حُسن التعامل معه برُقي، وإدارته بحِكمة ومن ذلك:التأكيدُ على لُزوم العدْل والإنصاف عند الاختلاف، وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، ولُزوم أحكام الله تعالى وأحكام رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم، التي هي العدلُ كلُّه.
ومن ذلك أيضًا :التنبيه على خَطر التجرُّؤ والمسارعة في التكفير والتبديع، والمبالغة والشَّطط في هذا، وأنَّ الخطأ في العفو أهونُ من الخطأ في العقوبة.
ولا مكان في الإسلام لضيق الأفق، والتشديد على الناس، بل يَسعك الإسلام بسماحته والدين بمرونته، هذا الدين الذي جاء ليرفع الأغلال، ويضع الإصر عن الناس.
من سمات الغلاة
ولقد رأينا في زماننا من الغلو والتشدد ومحاولة إلزام الناس بالقول الواحد مظاهر لا تكاد تقع تحت حصر وأصحابها يتصفون بسمات أهمها:
– التشدد والغلظة في التعامل، والخشونة في الأسلوب والفظاظة في الدعوة.
– سوء الظن بالآخرين فالأصل عندهم الاتهام؛ والأصل في هذا الاتهام الإدانة، فهم يرجحون احتمال الشر على احتمال الخير.
– البحث عن المثالب، والتنقيب عن الأخطاء، فلا تستوقفهم حسنة، ولا تنفع معهم سابقة.
وهذا المتشدد الغالي يبحث عن مجتمع خيالي لأنه يطوف بمثاليات لا يمكن أن تكن في مجتمع إنساني، فالمعصية عنده قرينة الكفر، والخطأ عنده مساو للعمد، والهفوة عنده لا غفران لها إلا قطع الرقاب، وهو لا يدري أن المجتمع لا يمكن أن يكون على أتقى قلب رجل واحد، فذلك محال في الواقع ومجانب للحقيقة [وخلق الإنسان ضعيفاً] (سورة النساء)، وقال سبحانه [ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين] (سورة يونس)
– كما يتصف أصحاب الغلو بضعف البصيرة في الدين، والجهل بالواقع والتاريخ والسنن الكونية.
لا بد أن يدرك الغلاة أن الدين سمح ويسير، وبعث به الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، فكان يسوس الناس بالحلم والصبر، والعفو فانتشر الدين وعم الآفاق، [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخروذكر الله كثيرا] (سورة الأحزاب).
عن اسلام.يبالمصدر
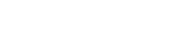





تعليقات الزوار ( 0 )